كمال زاخر
الكائن الحى العاقل السوى ـ الإنسان فى مجمله ـ يحتاج بين حين وآخر إلى لحظات للتوقف مع نفسه، يضبط بوصلته نحو الهدف الذى يعيش من أجله، حتى لا يتوه منه الطريق، شئ من هذا نبهنا إليه الرب يسوع المسيح، فى شخص الإبن الأصغر، الذى ذهب بعيداً فيما ظنه حياة افضل، وهناك بدد ماله فى عيش مسرف، النقطة المحورية التى اعادت وضع قدميه على جادة الطريق هى تلك اللحظة التى جلس فيها إلى نفسه
وأعمل فكره بحزم، وحين اكتشف أنه حاد عن الصواب كان قراره العودة الفورية لبيت ابيه
متحملاً تبعات العودة، كما ظنها، لكنه فوجئ بحفاوة ابيه، ليستكمل معه حياته، ابناً مدللاً ووارثاً مكرماً
اللافت أن معاجم اللغة تُعَرّف جادة الطريق بأنها “الطريق المستقيم”
وهو نفس معنى كلمة “ارثوذكسية” فى اليونانية.
نحتاج ـ افرداً وجماعة ـ الى اجراء مراجعات جادة وأمينة، ليس بالضرورة لوجود انحراف جسيم
فى مسيرتنا نحو الهدف، بل لنزيل ما علق بنا من غبار الطريق، الصاخب من حولنا
وتنقية مسيرتنا من تأثيرات المناخ ورياحه المحملة بالأتربة، وصراعات الأفكار المناهضة لإيماننا
والرافضة والمقاومة له.
وهو عين ما فعلته الكنيسة الأولى فيما عرف بعصر المجامع والذى انتج لنا وثائق ايمانية تترجم
ما صنعه وقال به الرب يسوع المسيح، وسجله تلاميذه ورسله فى الانجيل، بشائر ورسائل
وما سلموه لتلاميذهم، ايماناً معاشاً، بيقين وأمانة واختبار حياة.
على الرغم أن هذا العصر فى واحدة من اثاره الجانبية فتح باب الانقسامات الكنسية
وإن كان من المبشر أن الباحثين فى عصرنا ذهبوا إلى أن اختلاف اللغات بين الكيانات المسيحية الكبرى
أنذاك، كان له دوره الكبير
فى تعميق تلك الاختلافات بين مفردات اللاتينية ونظيرتها اليونانية، وهو ما يفتح مجدداً باب التقارب
والالتئام عبر منظومة الحوارات المسكونية التى لم تنقطع.
وذكرت غير مرة أن ازمتنا فى كنائس الشرق ـ العربى ـ يعمقها الانقطاع المعرفى الذى خضناه مرتين
أولهما حين هجرنا طوعاً اليونانية الى القبطية على إثر خلافات مجمع خلقيدونية 451م
على ارضية قومية، وثانيهما حين هجرنا القبطية قسراً الى العربية، وهى كلغة غير مهيأة
لتقديم تأويلات دقيقة للمفردات اللاهوتية مقارنة باليونانية.
واحدة من عناصر قوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “أنها كنيسة الشعب”، يرعاها ويخدمها “الإكليروس“
وهم ليسوا طبقة منفصلة عن الشعب، بل يختارون منه، وهذا سر بقائها رغم ما تعرضت له
من استهدافات واضطهادات دموية عاتية، حتى ارتبط تاريخها وتقويمها بالشهداء، شهداء الإيمان والعقيدة.
وكانت ليتورجيتها كلمة السر فى بقائها، ويعود الفضل هنا للفلاح المصرى ـ القبطى ـ الذى حفظها
وحافظ عليها وتوارثها عبر اجياله حتى فى اعتى احقاب التراجع والضعف، ومن بنيه خرجت اجيال سعت
وتسعى لاسترداد قواعدها اللاهوتية التى انارت الكنيسة الجامعة خاصة فيما يتعلق بلاهوت التجسد
الذى رسخه قامتان مصريتان القديس اثناسيوس الرسولى والقديس كيرلس الكبير.
وفى عصرنا الحديث كان العلمانيون باكورة باعثى النهضة ومؤسسيها، فى عدة اتجاهات:
ـ فهم من اعادوا الحياة للرهبنة القبطية، حين غامروا بطرق ابواب اديرتها وانخرطوا فيها
وكانوا من اصحاب المؤهلات العليا.
ـ وهم من راحوا يبحثون عن تراث الآباء اللاهوتيين المؤسسين، وينقلونها للعربية.
ـ وهم من أسسوا بيوت التكريس ويبعثون الفكر الارثوذكسى عبر دراساتهم وابتعاث الدارسين لضبط ايقاع التعليم اكاديمياً.
ـ وهم من أوقفوا مئات الأفدنة والعقارات لدعم الكنيسة مادياً
وهم من اسسوا لتنظيم موارد الكنيسة وضبط مصارفها بشكل مقنن حين شكلوا المجلس الملى
ووضعوا على رأسه البابا البطريرك فى تأكيد على التكامل بين العلمانيين والإكليروس.
وكانوا همزة الوصل بين الدولة والكنيسة، فتحقق من خلالهم اعادة الاعتبار لمقام الإكليروس
بعدم تعريضه للمصادمات السياسية وغيرها، وتفرغه لمهامه الروحية والرعوية، وأن كانت هذه التجربة
لم تكتمل بما كان متوقعاً لها، وقد جرت فى نهر الدولة والكنيسة مياة معوقة عديدة.
انتبه نفر من شباب الكنيسة مع منتصف العقد الأول للقرن الحادى والعشرين لحاجة الكنيسة
لدورة من دورات المراجعة، فشكلوا ما عرف “بالتيار العلمانى القبطى” وسعوا لطرح ودراسة
وتفكيك الاشكاليات القبطية المعاشة وتقديم حلول لها، وترجموا سعيهم فى سلسلة من المؤتمرات السنوية
المعلنة والمفتوحة، والتى استمرت لخمس سنوات (2006 ـ 2010).
وتوقفوا لأسباب عامة واسباب كنسية، فقد جاء العام 2011 بانفجار ثورة 25 يناير، التى أوجبت
على كل الوطنيين التفاعل معها ودعمها، فى لحظة فارقة، وكيف لا وشعارها “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية”
وتتسارع الأحداث وتُختَطف الثورة لتقع البلاد فى مأزق التيارات السياسية الدينية
ليخرج الشارع مجدداً ليسترد ثورته فى 30 يونيو 2013.
بالتوازى كانت الكنيسة تشهد رحيل قداسة البابا شنودة، وتولى المطران الانبا باخوميوس مهام القائمقام
فى مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، تنتهى بتجليس الأنبا تواضروس بابا وبطريركاً
وكلاهما قدم استعداداً لسماع رؤية التيار العلمانى القبطى، وقدمنا لكلاهما أوراقنا، البحوث والتوصيات.
تشهد الكنيسة مناوشات غائمة مع البابا الجديد، بعضها معلن بين الآباء الأساقفة
وتتأرجح المعالجات بحكم المواءمات، وبعضها يوَاجه بلى الذراع، والاستقواء بمراكز قوى هنا وهناك
لنجد انفسنا أمام اعادة انتاج لأجواء مطلع القرن التى اشرنا إليها، واسقط فى ايدينا
هل تحتمل الكنيسة انتهاج نفس نهج اطروحات التيار العلمانى، وكانت الإجابة ولما لا؟.
فنحن لم نكن يوماً فى مواجهة شخص، انما كان سعينا أن نقدم مخارج لاشكاليات فرضت نفسها
على المشهد الكنسى بدأت وتعمقت باستبعاد وتهميش العلمانيين، وانتهت الى الانفراد بالقرار.
وما يحدث اليوم هو تنويعة على هذا.
وعندما عدت الى اوراق التيار العلمانى ـ والتى وثقتُها فى كتابى الأول “العلمانيون والكنيسة ـ صراعات وتحالفات” الصادر عام 2009.
هالنى أننا لم نفارق ما كان، واترك القارئ مع سطور حملها البيان الختامى للمؤتمر العلمانى الأول (2006)
ورفع إلى قداسة البابا وأحبار وأراخنة الكنيسة الأجلاء تم التأكيد فيه على المبادئ التى حكمت
التحرك العلمانى وحرصنا على وحدة وتكامل الكنيسة وأرفق معه التوصيات التى خلص اليها اللقاء
وانقلها هنا كما جاءت بالكتاب.
[دعوة قداسة البابا شنودة الثالث وآباء المجمع المقدس وأراخنة الكنيسة إلى تشكيل لجنة
من المستنيرين لدراسة وتفعيل وتنظير وإقرار الأتى :
ـ تشييد جسور من العلاقات المتينة بين الأقباط والدولة من جانب، والأقباط والمجلس الملي
من جانب آخر من خلال تفعيل منظومة سياسات المواطنة.
ـ إعادة صياغة العلاقة بين الإكليروس وبين العلمانيين للخروج من حالة التبعية إلى حالة التكامل
لتطوير المؤسسة الكنسية من جانب، ولدعم ومساندة العلمانيين في العمل العام والمجتمع
من جانب آخر والإفادة من قدراتهم المتنوعة .
ـ إصدار مرجع قانوني للقواعد المنظمة للمحاكمات الكنسية.. موضحاً فيه: ضمانات العدالة
ودرجات التقاضي، وتوصيف المخالفات والجرائم والعقوبات وتدرجها، من خلال لجنة تضم خبراء
القانون العام والقانون الكنسى .
ـ وضع مشروع قانون بشأن المجلس الملي بداية من الاسم ـ بدلالته الطائفية ـ وأهدافه
واختصاصاته ولائحته، ومروراً بدوره الذي لا يشعر به المصريين الأقباط الذين انتخبوه
وصولاً إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به في مواجهة التوترات الطائفية .
ـ وضع مشروع قانون بشأن اختيار البطريرك، وفق القانون الكنسى بما يتفق وسمو هذا الموقع الرفيع
والعمل على وضع قواعد محددة لاختيار الأسقف والكاهن تحميهم من الصلف وتدفع خدمتهم
باتجاه رعاية متكاملة للرعية، وتنظيم تداول المواقع المساعدة لقداسة البابا والأب الأسقف سعياً
لعدم تكون مراكز قوى منهم، وانشاء آلية للإتصال فى المقر البابوى تتمتع بالشفافية والفهم الروحى
للتواصل بين قداسة البابا وابناءه، للحيلولة دون الوقيعة بينهم .

مراجعات ارثوذكسية 
كمال زاخر
وعلى الرغم من كل الإيضاحات الواردة فى هذه الأوراق ، وفى ورقة المبادئ وفى التوصيات
قوبل التحرك العلمانى والمؤتمر بوابل من الهجوم الشرس والذى شكك فى بل وأنكر على الفريق العلمانى
إيمانه وإنتماؤه للكنيسة فى تفعيل لنظرية المؤامرة وثقافة التكفير التى سيطرت على المجتمع برمته
ولم تتطرق الإنتقادات إلى فحوى الأوراق المقدمة والأبحاث المطروحة، بل دارت حول ميعاد الإنعقاد
ومشاركة غير الارثوذكس وغير المسيحيين، على الرغم من كونه اجتماعاً مدنياً وليس كنسياً
ويتناول فى جانب منه قضية المواطنة التى تهم كل شركاء الوطن، وكان واحداً من الأسباب
التى دفعت الوطن لإقرار المواطنة فى التعديلات الدستورية الأخيرة
( أقرها مجلس الشعب 19 / 3 / 2007 صدق عليها الرئيس مبارك فى 5 / 4 / 2007
وافق عليها الشعب فى استفتاء مارس2007).
الأمر الذى دفعنا فيما بعد لعقد المؤتمر الثالث لتناول بشكل موصوعى قضية المواطنة بعد إقرارها دستورياً
ومازلنا نبحث فى حتمية ترجمة نص المواطنة الدستورى فى منظومة قانونية تُفَعّله فى المجتمع
وتضبط العلاقات داخله على خلفيته والعلاقة الجدلية بينه وبين المادة الثانية وصولاً إلى نزع فتيل تلك الأزمة.]
ومازال للحديث عن العلمانيين والكنيسة بقية نطرحها فى مقال تالي.
 جريدة الأهرام الجديد الكندية
جريدة الأهرام الجديد الكندية 




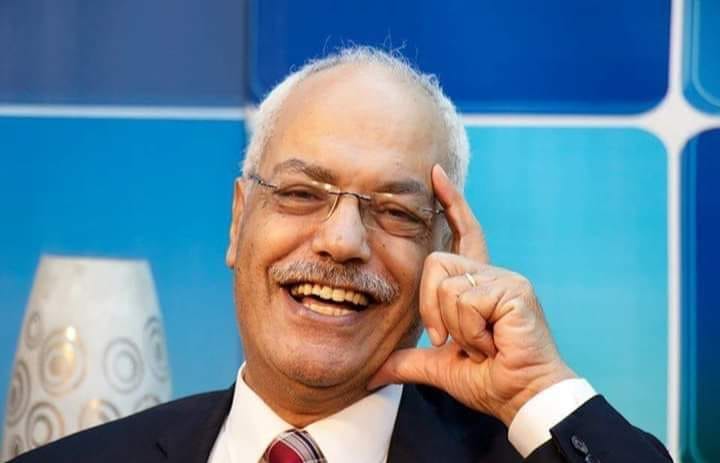


تجمهر الشعب من أجل شلح الكهنه عمل بلطجى وشلليه غير مسئوله …المفروض أن الناس تذهب الى الكنيسه من أجل المسيح وليس من أجل الكاهن ..وليس كل ما يعرف يقال ..وعملية شلح الكاهن تتم بعد دراسه وتحقيقات ومن غير المفروض أن يضطلع عليها أحد احتراما للكاهن المشلوح ولأسرته ومعاراه وأقاربه ..واحتراما للكنبيسه وقوانينها . ما علاقة الشعب بأسباب شلح الكاهن ؟ ناس تحشر مناخيرها فى أمور لا تخصها .