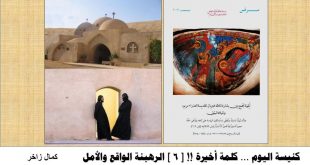كمال زاخر 22 ديسمبر 2022
فى ظنى ان كثيراً من ارتباكات التدبير الكنسى، وازدواجية المعاناة والمغالاة، التى تحاصرنا بدأت عندما تحولت المسيحية فى منطقتنا المطلة على شرق وجنوب البحر المتوسط وضفتى البحر الأحمر الى ديانة أقليات، وتحديداً بعد القرن العاشر الميلادى الذى بدأت معه موجات استهداف المسيحيين بالتوازى مع تعريب لسانهم
الأمر الذى تعاملت معه الكنيسة بواقعية يائسة بأن عربوا الصلوات والطقوس القبطية، وأظنه نفس التوجه الذى تبنته الكنائس السريانية والكلدانية،
مع فارق مهم أن الكنيسة القبطية لم تهتم بدعم بقاء القبطية لغة حياة حتى داخل الجماعة القبطية، فى حين بقيت لغات الجماعات المسيحية الأخرى حية ومتوارثة فى تعاملاتها الحياتية اليومية.
لكن الذى جمع بين كنائس المنطقة الناطقة بالعربية، رغم تعدد القوميات، هو المغالاة فى المظاهر التعبدية وفى هيئة الإكليروس الخارجية، ربما لتأكيد الوجود، وكان التشدد القبطى فى التعاطى مع الكنائس الأخرى احد مظاهر مقاومة الذوبان وفقد الهوية.
فى محاولة لاستعاضة غياب اللغة وفقدها، التى هى فى واحدة من تعريفاتها “وعاء الفكر والثقافة”، وهى فى اقتراب أخر “تمثل هوية وتراث وتاريخ الشعب الناطق بها”. وعلى هذا فاللغة القبطية ليست لغة دينية، بل هى النسخة الأخيرة للغة المصرية القديمة، وكان اقصاؤها هدفاً استراتيجياً عند القادمين الجدد،
كان مرحلاً حتى تستتب لهم الأمور وتتراجع أهمية الجزية كمصدر سيادى لخزينة دولتهم. وهو ما تحقق فى القرن العاشر وما تلاه.كان التحول القسرى عن القبطية لغة هو الثانى بعد أن سبقتها اللغة اليونانية التى كانت لغة الثقافة والعلوم واللاهوت فى العالم القديم وفى مصر تحديداً، والتى قدمت للعالم عبر مدرسة الاسكندرية مداخل وأسس ومدارس الفلسفة واللاهوت فى عصريها الوثنى والمسيحى، حتى وقع صدام خلقيدونية (451م)

والذى انحزنا فيه إلى القومية فكان قرارنا مقاطعة اليونانية لحساب القبطية، وتجرعنا مرارات الإنقطاع المعرفى الأول، والذى تكرر مع التحول للعربية بدءاً من القرن العاشر، وتدخل الكنيسة والأقباط نفق الانقطاع المعرفى مجدداً، وينعكس هذا على وعينا اللاهوتى الذى بقى على قيد الحياة بفضل بقاء الصلوات الليتورجية
(القداس والتسبحة والطقوس) التى خبأها القبطى فى قلبه وعقله، وتناقلتها اجياله المتعاقبة، حتى جاء عليه وقت كان يرددها دون أن يستوعب دقائقها وابعادها، وبحسب أحد الباحثين اللاهوتيين كان فضل بقاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لذلك الفلاح المصرى البسيط الأمين لتراثه وميراثه
والذى عبر به قرون هذا عددها حتى لاحت ارهاصات الاستنارة.فى تتبعنا لأزمة الكنيسة المعاشة امسكنا بخيط منهجها فى اختيار قياداتها، الأساقفة والبطاركة، فوجدناها فى قرونها الأولى تأتى بهم من علماء واساتذة مدرسة الاسكندرية، وحين اشتدت الصراعات العقيدية، كانت مدرسة الاسكندرية وعلماؤها هدفاً مرصوداً من القوى المناوئة للكنيسة بدعم من السلطات الحاكمة ـ الرومانية آنذاك ـ فحمل علماء المدرسة كنوزهم المعرفية ومخطوطاتهم ولجأوا للأديرة، احتماء بأسوارها

فذهبت الكنيسة فى إثر خطاهم لتختار منهم، ويبقى العلماء بالأديرة، وتستمر الكنيسة فى الاختيار من ساكنى الأديرة، ويدور الزمن دورته، ويصيب الأديرة ما أصاب المجتمع الكبير خارجها، وتدخل الأديرة نفس نفق الإنقطاع المعرفى، حتى أنه فى وقت كان المستشرقون يطرقون أبواب الأديرة وعيونهم على مخطوطاتها، يطلبون من مسئول الدير أن يسمح لهم بنسخ تلك المخطوطات، ويقدمون ما نسخوه له ويأخذون المخطوط الأصلى، بأوراقه المهترئة، فتنفرج اسارير الراهب العجوز ويدعو للمستشرق بطول العمر ويطلب له تعويضات السماء.
ويحتار المرء إزاء هذا الأمر، فقد وجدت هذه المخطوطات طريقها إلى مكتبات جامعات أوروبا وأمريكا وهى مكان آمن ربما حماها من أن تكون “وقيداً” لأفران الأديرة، أو طعاماً للفئران والإهمال. أو تدميرها على يد العربان والبربر فى غاراتهم على الاديرة، لكن هذا لا يمنع ما يصيب القلب من غصة وألم، قد يخفف منهما توفر خدمة الميكروفيلم، فى منتصف القرن المنصرم، الذى اتاح لبعض الأديرة، المهتمة بالبحث،
الحصول على نسخ منها، والباحثون خارجها أيضاً.
متغير نوعى حدث مع انتصاف القرن العشرين وتنامى بشكل مرتب وشكل منعطفاً تاريخياً رسم ما صارت إليه الكنيسة فيما بعد وربما حتى اللحظة ومرشح للبقاء لسنوات عديدة، هو انتباه شباب اربعينيات ذاك القرن لوضع الرهبنة كمدخل وحيد لمواقع قيادة الكنيسة، وهو ما أشرنا إليه قبلاً فى أكثر من موضع، ليس فقط فى هذا البحث لكن فى العديد من المقالات وفى سلسلة مؤتمرات التيار العلمانى السنوية (2006 ـ 2010)
وفى ما أصدرته من كتب فى حبرية البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث وفى حبرية البابا الحالى الأنبا تواضروس الثانى، وقد تُرجم هذا الاهتمام بدخول نفر منهم الدير
وتحديداً ثلاثة من نشطاء شباب مدارس الأحد، الاستاذ سعد عزيز، والدكتور يوسف اسكندر، وقصدا الدير عام 1948، والاستاذ نظير جيد وقصد الدير عام 1954، وتبعهم العديد من ابناء جيلهم سواء بتحفيز منهم أو من تلقاء انفسهم، باعتبار أن رواد الدخول يمثلون طليعة ذاك الجيل وقادته، وينتهى الأمر بوصول الأستاذ نظير جيد الى سدة البطريركية، بعد سنوات شهدت تحالفات ومواجهات عديدة ومتباينة، تستحق أن تكون محل بحث وتحليل بعيداً عن التربص والموالاة.
اصطحب البطريرك الجديد معه خبراته السياسية التى لم تنجح فى ترجمة طموحاته فى عالم السياسة، وكان حريصاً على صناعة أغلبية موالية داخل مجمع الاساقفة، وكانت الرياح مواتية، فأغلب المطارنة وقتها كانوا كهولاً، وايبارشياتهم مترامية الأطراف، وتضم أكثر من محافظة، وكان رحيل أحدهم يقابل بتقسيم الإيبارشية إلى ثلاث أو خمس ايبارشيات، وكان التفسير، ايبارشية صغيرة لخدمة مركزة، كان اللافت اختيار رهبان لم تكتمل خبراتهم الرهبانية ولم تتح لهم فرصة التلمذة على شيوخ الدير،
وبعضهم لم تدم اقامتهم بالدير بضعة شهور، كان المعيار انهم حاصلون على شهادات جامعية فى كليات القمة، بينما لا يقابلها المثيل فى الدراسات الكنسية اللاهوتية، وهؤلاء يمثلون اليوم رأس الحربة فى مقاومة المراكز البحثية الاكاديمية، التى تعمل فى دوائر الدراسات الآبائية الاكاديمية.
اللافت فى هذه الظاهرة أن الأقل علماً هو الأعلى صوتاً، ويوزع اتهامات الهرطقة ببذخ لافت على كل ما لا يستوعبه.
فى كنائس الجوار وعلى الرغم من خلافاتهم التاريخية لكنهم قفزوا فوقها دون أن يفرطوا فيها،
إلا أنهم بحثوا عن خيط يربطهم ويمكن أن ينطلقوا منه إلى أن يلتقوا بعد جفاء قرون، فوجدوه فى اتفاقهم فى اصولهم السريانية، فمنهم خلقيدونيون ومنهم لا خلقيدونيين، ارثوذكس وكاثوليك ونساطرة، واللقاء فى هذه الأجواء خطوة مهمة وكبيرة، وأظنها تمهد لمناقشات موضوعية وجادة فى ضوء تقدم علوم التحليل النقدى، واتفاق الثقافات، ووحدة الهدف.
ولهذا جاءت الصورة المرفقة تحمل تصور أن تكون كنيستنا ضمن هذه الخطوة وعندها ما تطرحه بتاريخها وثقلها اللاهوتى والبحثى. وتضم الصورة :
1 – بطريرك الكلدان في العراق والعالم: الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو
2 – بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة في العراق والعالم: مار آوا الثالث روئيل
3 – بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس: مار إغناطيوس أفرام الثاني
4 – بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة: الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
5 – بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي: مار إغناطيوس يوسف الثالث يونانثمة ملاحظة أخيرة أن هذه الكنائس لا تقوم بتقديم أحد الى رتبة الأسقفية إلا بعد اجتيازه سلسلة من الدراسات النظامية الأكاديمية تمتد فى بعضها إلى ما يزيد عن العشر سنوات، يرافقها تكليفه بالخدمة فى مواقع كنسية متعددة، تبنى خبراته الرعوية والتعليمية، وهو الأمر الذى يجب على كنيستنا الأخذ به، فى مواجهة الطفرات المعرفية التى يعيشها اجيال الكنيسة الواعدة.ومازال للطرح بقية.
 جريدة الأهرام الجديد الكندية
جريدة الأهرام الجديد الكندية